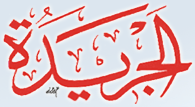
لحظة الإبداع أو الالهام
التاريخ: Thursday, March 28
اسم الصفحة: ثقافية
د . فاروق اوهان
إن لحظة الإبداع . أو لحظة الالهام هي اللحظة القابلة للقدوم من خلال بؤر، ولحظات الإدراك .. والاختزان .. ثم الإفراز ... هي لحظة نادرة التموضع، متاهية في الأنا، ولا تجيء بسهولة، إنما قد يتم استدعاؤها بوسائل يتعلمها المبدع، ويمارسها من خلال مفاتيح خاصة، ربما يستدعي ذلك سبر أغوار الذاكرة المعلوماتية من جهة، وينابيع الإلهام من جهة ثانية، فليس الحالات متشابهة، لا لدى المبدعين فحسب، وإنما لدى المبدع لمفرده بالذات.فمن أين يأتي الإبداع .. ومتى تكون لحظته المناسبة ؟؟؟إن هذا ليس سهلاً، ولا بالممتنع لأننا نشير هنا إلى الإبداع الذي لا يأتي إلا من مبدع .. وللمبدع مواصفاته وشروطه الذاتية الفطرية - الغريزية، وربما من خلال جينات وُهبها المبدع، لكنها ليست بالضرورة إبداع راق، إنما هو إبداع في مراحله الأولى، أو كما يدعى بالإبداع الفطري، أو الطفولي ..
وهنا تأتي الخبرات المكتسبة، والتعليم المكتسب من خلال نظريات تراكمت لدى الشعوب، نظمت في نظريات، ومدارس خاصة تنمي قدرات الموهوب، وتختصر عليه الزمن من جهة، وتوصل المبدع إلى آخر مستجدات التطور الإبداعي، وما تزال الأمور قيد الدراسات البحثية، والتطور ما دام الإنسان باحث مستديم في مجاهيل العقل والطبيعة ...نقل المرموزات.. لحظة الإبداع .. هي لحظة تسامي يقودها فعل اللحظة .. وومضات صغيرة .. لكنها نيّرة تدق مثل نواقيس، ولا يحبسها أي عائق، من غير حسابات. فهي لحظة لا تعطي مهلة لصاحبها، تظلّ تلّح عليه .. ومتى ما وضعها في شكلها الفني، وحاول توصيفها تحرر كل منهما من الآخر، وصار هو واحد من هؤلاء المسكونين خارجها، يرى إليها كأنه شخص آخر غير المبدع الذي خلقها، وشكّلها لتكون كائن مادي أمامه .. بمعنى أن الفكرة الإبداعية التي تتشكل في المخيلة كأحد الافتراضات، تكون كتلة صلدة، وفكرة مكورة على بعضها بحاجة لقوالب مادية، وأوعية واقعية تتموضع فيها، بشكل أو بآخر، وهنا يأتي دور المبدع، ورغبته في صبها في القالب العام المناسب فنياً، "رسماً، تصويراً، كتابة، لحناً، والعديد من الأشكال الفنية" لكن لكل شكل فني خصوصيته، وأدواته التي تؤطر الفكرة المتخيلة حين جلبها لأرض الواقع، وتشكيلها كمادة ملموسة، فالفكرة المختزنة في مخيلة المبدع هي حالة تختلف عما ستكونه في الواقع كفعل عملي، وبين هاتين الوضعيتين هناك عملية جدلية، وارتقائية تنقل الصور الضبابية من المخيلة إلى الواقع الملموس، بتفاعل إلهامي ثان؛تشبه هذه الحالة ما نقوم به في الواقع ولكن بشكل معكوس، وهو أننا لو أردنا وصف مشهد ما "منظر عام لنهر وشجرة وراع بجانبها" كتابة في شكل من الأجناس الأدبية: رواية، قصة، حكاية، أو شعراً، فإن ذلك يتخذ منا سطوراً طويلة بالكتابة، ودقائق معدودة بالوصف الروائي الكلامي، ولكن هذا المشهد يقوم الفن بتصوره كحالة بيئية واقعية في كل من: السينما "الأكثر واقعية"، والتلفاز، والمسرح، وربما حتى اللوحة الفنية، "عدا عن مراحل إعداد المشهد التي قد تتجاوز الأيام"، ولكن ما نتكلم عنه هو وجود المشهد مصوراً أمام المتلقي يختصر الكثير من الوصف، ويبقى على المتلقي واستيعابه للصورة أهمية فهم المشهد المتجسدة في الحال أمامه. هذا الأمر يبدو معكوساً، أو مترجماً لما نريد توضيحه، فالصور التي تشيئؤها بيئياً فنون الصورة كالسينما هي ما تمثل الصور الذهنية المتراكبة في المخ، والمخيلة لو أردنا، أما الرواية والكتابة فهي الترجمة الفعلية لتلك الصور.ويشابه هذا الوصف ما يحدث لدى الحالم الذي يستأنس لحلم، ويتفاعل معه، ولكنه حين يستيقظ يحار في كيفية وصف الصور الضبابية التي تفاعل معها في الحلم، وتعايش معها كأنها واقع محسوس، وتقبل رموزها كأنها لغة مشتركة، ولكنه حين يستيقظ ليروي الحلم لنفس، أو للآخرين فإنه يبحث عن عبارات تتناسب والصور التي رآها، ولكنها لا تكفي، حتى ولو روى الحلم مئات المرات.إن العملية الإبداعية تبدأ هنا لتتشكل من جديد على ضوء المعطيات المادية للخلق، وتجسيد الفكرة في واقع ملموس من كلمات، أو ألوان، أو أصوات، وما إليها، وهنا يأتي دور الأدوات في إضافة العامل الإبداعي المادي على العامل التخيلي، وإعادة تشكيله بما يتناسب وعملية الفرز، إذن فإن عملية الفرز الجديدة تسبق عملية النقل من أفكار وهمية، إلى أعمال تتجسد في كيان مادي، عملية النقل هي عملية التجسيد الأهم والتي يأتي فيها دور الفنان، وإمكانيته الإبداعية في القدرة على تشكيل تلك الصور الضبابية المسبرة من المخيلة، إلى مادة منقولة من الأنا، إلى الآخر حتى ولو كان الآخر المستقبل هو المبدع نفسه، هي حالة إحالة كل المرموزات التي يحملها المبدع كرسالة فنية، وفكرية ينقلها عن طريق هذا العمل الفني إلى المستقبل، مرموزات لا بد أن تلقى ترحاباً لدي المستقبل لكي يستوعب ما يريد المبدع التعبير عنه، وإلا فإن حالة الإبداع سوف تتلاشى، وتصبح نوعاً من الغموض، أو نوع من الصناعة العادية، كعمل النجار الذي يصنع باباً، تعّلم حرفية تنفيذه بالوراثة، لكن أول من صنع الباب كان بالتأكيد هو الخالق المبدع، والفنان الذي ابتكر شكل الباب العادي، ولهذا فإن الفكرية الفنية المنفذة إذا لم تلتق وفهم المستقبل الذي يشاهدها، أو يتعامل معها، تفقد خواصها الهامة، وهي نقل حالة إبداعية راقية من فنان، إلى مستقبل بحاجة لهذه المبتكرات.لهذا يكثر الشعراء في عصر معين، ولكن لا يستمر في ذاكرة الناس جيلاً بعد جيل إلا المميز، والذي يمثل العصور كلها، مثل المتنبي، شكسبير. بيكاسو، وغاودي، باخ، وسترافينسكي. رودان، ومور، على سبيل المثال لا الحصر، إذ يطول الكلام، وتكثر الأمثلة، تتعقد، وهذا ليس مجالنا هنا .
التشابه والأسريقال إن التمثال الذي يحدّق بالإنسان، واللوحة التي تتابعه "في متحف . أو دير مهجور"، هي حالة من التواصل بين المستقبل، وروح صماء بكماء، والعيون الحجرية، أو الملونة بالزيت هي روح .. كحالة تواجد الآخر فينا، أو كمن يقول المثل الشعبي بأن هذا ممسوس من الجان .. هذا الآخر في العمل الفني يتابعك كأن هناك سجين يستنجد انقاذه حتى وأنت تستدير، فإن عيونه تتابعك، العيون هي منافذ العمل الفني حتى ولو لم يكن لوحة شخصية، العمل الفني يبصر المستقبل "بكسر الباء" كما يفعل المستقبل نفسه، وهنا تتم عملية التواصل بين المبدع في عمله الفني، وبين المستقبل لرسالة المبدع من خلال ما سميناه بالمرموزات المتعارف عليها بين الطرفين، هي كما قال جان جينيه: إن روح الفنان صانع العمل الفني مهما قدم .. تلتقيك فجأة في لحظة إبداع.إن حالة انتقال فكرة الإبداع إلى المستقبل، هي كما يحدث عندما يلتقي الجمهور بالعمل الفني، فإن رعشة غريبة تمسه في الصميم، وتسري في كيانه، وتسبر أغواره .. هذه الرعشة هي الهاجس المطلوب في العمل الفني الناجح لدى الجمهور، وليس غير .. "كالتصفيق" . تذّكرني حالة الرعشة هذه بحالتي عند الحضور أمام تمثال الملك سنطروق في مدينة الحضر، فهذا التمثال رغم قدمه لقرون عديدة، لكنه ظل مؤثراً في بيئته بشكل موهوم، حتى قبل امتشافه، وربما بتفاعل الذاكرة الجمعية لدى الشعوب، مما جعلني أنشد لحالة تشابه بين وجه الملك سنطروق الحجرية في التمثال الماثل أمامي في موقع الحضر، وبين الشبيه الحي، وهو الحارس الذي تعمّد الوقوف إلى جانب التمثل. وكأن هذا البدوي يقول لي ها أنذا أمامك فحاكني؟ فلم أتوان عن تصويرهما مع بعض، وتصوير كل منهما على حدا، وبعملية "Superimpose" فنية بالأسود والأبيض، قمت بالمطابقة بينهما، فخرجت لوحة فوتوغرافية فنية ترافقني في كل صباحاتي، وأتأملها مثلما كنت أتأمل لوحات دير مار أوراها، وعيون القديسين التي ترافق المشاهدين منذ دخولهم حتى خروجهم بشكل ممتع لي، ومفزع لغيري، ومبارك للآخرين .. ربما لأن الرطوبة التي أشيعت في المكان جعلت الصور تتكلّم ليس بالعيون فقط، وإنما كأنك تحس بأن يد من الصورة تمتد لتخرج منها فتطوقك لتأسرك؟
|