| |
 تأليف :بوريس كامبريلان تأليف :بوريس كامبريلان
يركز المؤلف في هذه الحلقة على مظاهر ومدلولات النمو الاقتصادي الصيني الهائل من حيث الارتفاع النسبي لمستوى دخل الفرد وقدرته الاستهلاكية، ولكنه يشير إلى أن السواد الأعظم من الشعب الصيني، أي ما يعادل مليار نسمة، لا يزال غير قادر على شراء بعض السلع الاستهلاكية نتيجة لضيق ذات اليد، بينما شهد المجتمع الصيني ظهور فئات مترفة من الأغنياء الجدد الذين يملكون ثروات طائلة تمكنهم من شراء معظم السلع الغالية شأن نظرائهم في الغرب.
ومن أبرز مظاهر النمو الاقتصادي تزايد الإنتاج الصناعي الصيني الموجه للتصدير وتنامي حصة الصين في الأسواق العالمية، خاصة في ظل تطور المستوى التقني لتلك المنتجات ومدى جودتها مع تحول التكنولوجيا العالية إلى الصين وتزايد أعداد الطلبة الصينيين الذين يعودون إلى الوطن بعد إنهاء دراستهم في الغرب.
الصين هي أكبر أمة وأكبر دولة في العالم. وكانت الحكومة الصينية قد أعلنت في شهر يناير من عام 2005، ان عدد سكانها قد بلغ مليار وثلاثمئة مليون نسمة. لكن إذا كان عدد السكان الهائل هذا يشكل ورقة رابحة في مجال توفر اليد العاملة، فإن هناك عاملا أكبر في جعل اليد العاملة ويتمثل هذا العامل في الحركة التي عرفها الصينيون والانتقال إثر تبني الإصلاحات باتجاه اقتصاد السوق.
إن الهجرة الريفية تسارعت كثيراً وغدا عمال المصانع والعاملين في مختلف الورشات هم من الفلاحين والمزارعين الذين تركوا أراضيهم للحصول على أية فرصة عمل في المدن حيث توجد أعداد مهمة منهم أيضا في قطاع البناء المزدحم بينما اكتفى الكثيرون منهم بالعمل في المهن الصغيرة من قطاع الخدمات. وكان العقدان الأخيران قد شهدا تبدلا عميقا في توزع السكان بالصين بين سكان المدن والأرياف.. إذ لم يكن يعيش في المدن قبل عشرين سنة فقط سوى نسبة لا تزيد بالكاد على 20% من مجموع السكان بينما يعيش اليوم أربعة صينيين من أصل كل عشرة في المدن والتجمعات المحيطة بها. ويلاحظ ان المناطق التي شهدت نمواً اقتصاديا كبيراً مثل المناطق الشاطئية كشنغهاي وغيرها قد جذبت الأيدي العاملة من الأرياف ومن بعد آلاف الكيلومترات أحيانا. لكن هذه اليد العاملة الشابة، ورغم تواضع تأهيلها المهني، وبالتي تقبل العمل بشروط قاسية جدا هي في واقع الأمر أحد الأعمدة الأساسية، هذا إذا لم تكن العمود الفقري في تحقيق المعجزة الاقتصادية الصينية، ويشير مؤلف الكتاب في هذا السياق إلى وجود أعداد ضخمة من العمال الشباب الذين يعملون غالباً طيلة أيام الأسبوع وينامون في مهاجع ملاصقة لأماكن عملهم. وأغلبية هؤلاء العاملين هم من الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 25 سنة ولم يتزوجن ولم ينجبن. لكن رغم الازدهار الاقتصادي الكبير الذي تحقق فإن أجور العاملين لم ترتفع إلا قليلاً. وهكذا مثلاً شهدت منطقة "غوانغ دونغ" خلال عشرين سنة نمواً اقتصاديا ومحلياً سنويا بمعدل 20% لكن أجور العاملين لم ترتفع سوى بنسبة ضئيلة جدا.. وكان من نتيجة ذلك ان الشح في اليد العاملة عام 2004 قد أصبح واضحا في هذه المنطقة الجنوبية التي توجد فيها مدينة شيغزهن التي تحتل المرتبة الأولى في ميدان التصدير بين جميع المناطق الصينية. ويقدر الاختصاصيون عدد السكان العاملين في المدن بما بين مئة ومئة وخمسين مليون نسمة، هؤلاء العمال تتم معاملتهم وكأنهم مهاجرون في داخل بلادهم إذ انهم لا يمتلكون "أوراقاً نظامية" مثل هذا الأمر يعود إلى وجود نظام "دفتر الإقامة" فالصيني المولود في الأرياف أي المولود كفلاح، لا يحق له أن يمتلك المكانة القانونية لابن المدينة وبالتالي لا يتمتع بالإمكانيات المترتبة على ذلك في ميادين الحصول على المسكن وكذلك فيما يتعلق بالتربية والخدمات الصحية. سوق داخلي هائل بالرغم من التلفزة الاقتصادية الهائلة التي حققتها الصين ولا تزال مستمرة بها، فإن القدرة الشرائية للصينيين لا تزال محدودة فهي تتقدم بخطى أكثر تمهلاً من التنمية، فبالإضافة إلى مسألة الاستهلاك تتحمل الدولة أعباء استثمارات كبيرة في ميادين التجهيزات والبنى الأساسية للبلاد. يتوزع المستهلكون الصينيون، كما يضعهم مؤلف هذا الكتاب "بين ثلاث فئات أساسية. أولا هناك فئة الأغنياء التي تستطيع الاستهلاك مثل نظيراتها في البلاد المتقدمة وتشتري عطور كريستيان ديور وحقائب فويثون وغيرها من المنتجات الراقية ـ منتجات اللوكس ـ ويبلغ عدد "أعضاء" هذه الفئة ما بين 30 إلى 50 مليون نسمة ويستطيعون أيضا شراء سيارة "مستوردة" والقيام برحلات سياحية إلى الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وغيرهما. الفئة الثانية تضم مجموع "الطبقات الوسطى" أي ما يمثل ما بين مئتي وثلاثمئة مليون صيني.. وكانت هذه "الطبقات" قد برزت خلال فترة صعود الصين الاقتصادي وتبلغ قدرتها الشرائية ما بين 200 و 500 يورو شهرياً بالنسبة للفرد البالغ، أي أنها لا تزال أدنى من نظيراتها في البلدان المتقدمة. لكن هذه الطبقات الوسطى الصينية الصاعدة تتسع شرائحها وتسعى إلى تحسين شروط معيشتها. الفئة الثالثة من المستهلكين الصينيين تضم حوالي مليار نسمة، أي السواد الأعظم من الشعب، والقدرة الشرائية لأبناء هذه الفئة لا تزال محدودة جداً، وهناك حوالي مئتي مليون نسمة من الصينيين لا يزالون يعانون من "الفقر المدقع" أي يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم حتى الآن. ان مجرد إلقاء نظرة على توصيفات الفئات الثلاث المذكورة للمستهلكين الصينيين تبين مدى التفاوت المرعب بين مكونات المجتمع الصيني الحالي. لكن هذا لا يمنع واقع ان بلوغ بعض السلع قد تعمم إلى درجة كبيرة في الصين وبسرعة فائقة. هكذا تدل الاحصائيات مثلاً على أن الصين تحتل منذ عدة سنوات المرتبة الأولى في العالم في نهاية عام 2005 فيما يتعلق بالخطوط الهاتفية بوجود 350 مليون خط هاتفي ثابت و395 مليون هاتف نقال أي ما يمثل ضعف ما تمتلكه الولايات المتحدة الأميركية. مع ذلك ورغم وجود 30 هاتفاً نقال و27 خطاً هاتفياً ثابتاً بالنسبة لكل مئة صيني فإن السوق لا يزال يحتاج إلى الكثير في هذا القطاع إذ لم يبلغ درجة الإشباع إلا في بعض الاستشارات القليلة مثلما في المدن الكبرى كبكين العاصمة حيث تدل الاحصائيات على وجود حوالي 99 هاتفاً نقالاً لكل مئة شخص، وكان عدد الهواتف النقالة قد ازداد بـ 6, 58 مليون هاتف في البلاد كلها عام 2005 بينما ازداد عدد الخطوط الهاتفية الثابتة 7 ,38 مليون خط حسب مصادر وزارة الاتصالات. وكانت الشركة الفنلندية للهواتف النقالة "نوكيا" قد قامت بتصنيع مئتي مليون من الأجهزة في الصين نصفها مكرس للسوق الداخلية والنصف الآخر للتصدير. وفي هذا القطاع مثلما في القطاعات الأخرى سيكون على الشركات الأجنبية ان تأخذ في حساباتها المنافسة المحلية ذلك ان الهواتف النقالة المبيعة في الصين مثلا قد جرى تصنيعها وتسويقها من قبل الشركات الصينية. ولم تغب أهمية السوق الداخلي الصيني عن مجموعات التوزيع التجارية الكبرى المجسدة في عدد من سلاسل المخازن مثل "كارفور" و"اوشات" و"وول مارت" وغيرها التي يمكن مشاهدتها في شتى أنحاء العالم، كما أدركت المجموعات المعنية مدى التبدل الكبير الذي حدث في ميدان الاستهلاك بالصين حيث برزت طبقات وسطى مؤلفة من عدة مئات من الملايين وتتمتع بقوة شرائية متصاعدة. هكذا نرى مثلاً ان مجموعة "كارفور" الأوروبية قد افتتحت في نهاية عام 2005 ما مجموعه 69 مخزناً عملاقاً في العديد من المناطق الصينية، لتتجاوز بذلك المجموعة الأميركية الأولى في العالم بميدان التوزيع أي "وول مارت" التي كانت تدير في نفس الفترة 56 مخزناً على الأرض الصينية. ومثال آخر له دلالته يخص قطاع بيع السيارات، وكانت مبيعاته قد شهدت تزايداً متسارعاً خلال عامي 2002 و2003 ثم تباطأت خلال عام 2004 كي تعود للإقلاع من جديد في عام 2005. وتدل الاحصائيات الحالية على ان المعدل العام لامتلاك السيارات في البلاد هو 7 سيارات لكل ألف مواطن صيني؟ وهذا يعني ان السوق الداخلي الصيني لايزال بعيداً جداً عن الوصول إلى درجة الاشباع أو الاقتراب منها، وبالتالي لايزال حجم الطلب "الافتراضي" فيه كبيراً جداً. وفي جميع الحالات هناك قطاع أساسي لا يمكن للمستثمرين الأجانب اهماله بالإضافة إلى الهدف المتمثل في المستهلك الصيني، ويتمثل القطاع المقصود في مشاريع البنى التحتية والتجهيزات التي تقوم بها الحكومة ومؤسسات الدولة ذلك ان الصين، وكما تدل الاحصائيات، تحتل المرتبة الأولى في العالم بين البلدان فيما يتعلق ببناء الطرق والسكك الحديدية والمحطات الكهربائية. ولاشك ان هذه القطاعات كلها تشكل ميداناً للمنافسة الشديدة بين كبار الشركات العاملة فيها من أجل الفوز بالعروض المقدمة؟ وهي مستعدة إلى تخفيض هوامش ربحها والى القيام بعمليات تحويل كبرى للتكنولوجيا لتعزيز مواقعها في السوق الصيني، ويشير المؤلف، بالاعتماد على معلومات نشرتها صحيفة "الفايننشيال تايمز"، إلى ان بكين تقوم بتحضير عمليات دخول إلى البورصة تؤمن لها حوالي 250 مليار دولار بعقد تمويل 25000 كيلومتر من السكك الحديدية الإضافية من الآن وحتى عام 2020. ومن الملاحظ ان الشركات الفرنسية الكبرى العاملة في حقل إنتاج الطاقة، وخاصة النووية منها، متواجدة في الصين منذ عشرين سنة حيث شاركت في بناء أربعة مفاعلات من أصل تسعة لإنتاج الطاقة النووية العاملة في البلاد اليوم. ويبدو ان مجموعة "اريفا" الفرنسية العاملة في ميدان الطاقة النووية هي الأوفر حظاً في الحصول على عقود خاصة ببناء أربعة مفاعلات نووية من الجيل الجديد بالإضافة إلى أربعة مفاعلات تقليدية. وتضع الصين في خططها من الآن وحتى عام 2020 إنتاج 1000 ميغاواط، أي ما يعادل بناء عدة مفاعلات نووية جديد لإنتاج الطاقة. إن المنافسة شديدة بين الأميركيين والفرنسيين والروس لولوج سوق "الطاقة النووية" الصيني.. والتكنولوجيات التي سوف يتم تبنيها سوف تكون حاسمة بالنسبة لمستقبل الخيار الصيني في هذا الميدان. وينقل مؤلف الكتاب عن رئيس الوزراء الصيني "وين جياباو" تصريحه في لقاء مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية قوله: "إننا ننتظر تعاوناً ابتداءً من المحروقات ووصولاً إلى معالجة النفايات ومروراً بإنتاج الكهرباء وضمان أمن المفاعلات، "ثم الإعراب عن أمله بأن "تزيد الشركات الفرنسية من قدرتها التنافسية". إنتاج كل شيء لم تكن الصين حتى فترة قريبة من الزمن سوى مجرد بلد تعمل شركاته لحساب الآخرين في أحيان كبيرة لإنتاج بعض المواد ذات القيمة المضافة الضئيلة.. هذه الصورة تغيرت كثيراً إذ ردمت الصين هذه الهوة التكنولوجية بسرعة فائقة مستفيدة بشكل خاص من "الشهية" الكبيرة التي أظهرتها الشركات متعددة الجنسيات حيال سوقها. وهناك اليوم عدد مهم من الصناعات المتواجدة خاصة على طوال الشواطئ في الربع الجنوبي ـ الشرقي للبلاد تعمل في الإنتاج لحساب بعض الشركات متعددة الجنسيات. ومديرو المصانع المعنية هم في أغلب الأحيان من الصينيين الذين تعود أصولهم إلى تايوان أو هونغ كونغ. ومن أهم النشاطات في هذا الميدان هناك صناعة الألعاب بشكل خاص، والتي تظفر فيها الصين بحصة الأسد، إذ تستأثر بحوالي 75% من السوق العالمي فيما يخص 90% من الإنتاج المكرس للتصدير، وهناك أيضاً صناعة الأحذية الجلدية التي تصل حصة الصين منها في السوق العالمي إلى 40%، وقد كان لهذا الواقع تأثيره على أسواق العديد من البلدان، وهكذا تضاءل إنتاج الأحذية الفرنسية إلى ثلث ما كان عليه خلال عشر سنوات، وحيث أفلست بعض شركات إنتاج الأحذية الراقية مثل مؤسسة ستيفان كيليان، وبدت شركة "شارل جوردان" على وشك الإفلاس في شهر أغسطس من عام 2005. وإذا كان الحديث يتم كثيراً عن الاجتياح الصيني للأسواق العالمية فيما يخص السلع والمنتجات التي نجدها على رفوف المخازن، فإن قطاعات أخرى، أقل ظهوراً، بالنسبة للمستهلك العادي، توضح أيضاً مدى التقدم السريع الذي أنجزته الصين.. المثال الواضح على هذا يقدمه قطاع الصناعات الحديدية، إذ غدت الصين هي المنتج الأول في العالم للحديد والفولاذ منذ عام 1996، إذ تؤمن أكثر من ربع الإنتاج العالمي، وربما أكثر من ثلثه من الآن، وحتى عام 2010، حسب بعض المصادر الاقتصادية الفرنسية. وهناك اليوم حوالي 1000 صانع للحديد يتنازعون السوق فيما بدأت موجة من عمليات اندماج شركات التصنيع تشارك فيها المؤسسات الأجنبية بقسط كبير. وعلى صعيد الأجهزة الكهربائية فإن الفارق الزمني بين طرح منتوج جديد في السوق وتصنيعه بكميات كبيرة أصبح يضيق أكثر فأكثر، ففي عام 2005 يفترض أن يصل الإنتاج الصيني لأجهزة التلفزة ذات الشاشة المسطحة التي تحل تدريجياً محل الأجهزة التقليدية إلى 85 ,1 مليون جهاز، وكانت شركة "شارب" اليابانية التي تمثل المنتج العالمي الأول لأجهزة التلفزيون المسطحة، قد عرفت انخفاضاً في دخلها الصافي بنسبة 7% خلال عام واحد، وذلك بسبب منافستها من قبل بلدان ذات كلفة أدنى في عملية الإنتاج مثل تايوان و كوريا الجنوبية، ولكن أيضاً، وربما أساساً، الصين. وفي الوقت الذي يوجد فيه تلفزيون ملون في كل بيت صيني تقريباً، فإن شركات التصنيع في البلاد تتجه نحو إنتاج الأنواع الأكثر فخامة ورقياً، هكذا أعلنت شركة "شانغ هونغ" مثلاً أن جميع الأجهزة التي سيتم إنتاجها عام 2006 ستكون قادرة على استقبال البرامج التي تتطلب أعلى التقنيات، ويدل تقرير اقتصادي جرى نشره عام 2004 على أن حصة الإنتاج الصيني من الأجهزة الكهربائية بالنسبة للإنتاج العالمي قد ازدادت من 10% إلى 18% خلال أعوام 2000 إلى 2003، أي أنها حققت نمواً سنوياً يزيد على 15%، كذلك تطول أكثر فأكثر قائمة الأجهزة التي كان يتم إنتاجها غالباً قبل عقد من الزمن فقط في ماليزيا أو سنغافورة أو تايوان أو كوريا الجنوبية والتي أصبحت تنتج غالباً في المقاطعات الصينية الشاطئية. ولقد أصبحت الصين هي المنتج الأول في العالم لأجهزة التلفزة وكذلك لأجهزة الحاسوب المحمولة وهي باتت اعتباراً من عام 2004 المصدر الأول لتكنولوجيات الاتصالات والإعلام من حواسيب محمولة وهواتف نقالة وأجهزة تصوير رقمية حسب دراسة نشرتها "منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية" يوم 12 ديسمبر 2005. وكانت الشركة الأميركية العملاقة "آي بي ام" مخترعة حاسوب المكتب، والتي تدنى ريعها كثيراً خلال السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة، قد باعت عام 2004 هذا القطاع ـ حاسوب المكتب ـ من نشاطاتها لمجموعة "لونوفو" بمبلغ 25 ,1 مليار دولار، وبالتالي وبالمقابل امتلكت الشركة الأميركية العملاقة نسبة 9 ,18% من شركة لونوفو الصينية التي أظهرت براعة كبيرة في مجال اللغة الرقمية الالكترونية. ومن الواضح أن هذا الفرع، مثل الفروع الأخرى من الصناعة الصينية، قد حسّن كثيراً من مردوديته منذ دخول الصين إلى منظمة التجارة العالمية في نهاية عام 2001. هكذا برزت بعض الشركات الوطنية الصينية ذات التبعية الأقل حيال التكنولوجيات الأجنبية. من سمع، خارج الصين، بأجهزة تبريد ـ برّادات ـ تحمل ماركة هايير وحواسيب تحمل اسم لونوفو وأجهزة تلفاز من نوع كونكا؟ ربما هناك عدد قليل من الناس قد سمعوا بهذه الماركات، وهذا تحديداً ما يعتبر مؤلف الكتاب لا يزال يعاني منه الاقتصاد الصيني بالقياس إلى السمعة الكبيرة على الصعيد العالمي لماركات مثل سوني وهوندا اليابانيتين وسامسونغ الكورية الجنوبية. "طغيان" شهرة الماركة فعل فعله أيضاً في الصين نفسها لفترة طويلة من الزمن، إذ كان المستهلكون الصينيون يفضلون شراء الماركات الأجنبية عندما تسمح إمكاناتهم بذلك. لكن مثل هذه الصورة قد تغيرت تدريجياً إذ أصبحت الغلبة واضحة للمنتجات الصينية في السوق الداخلي، في ما يخص الأجهزة الكهربائية المنزلية وأجهزة التكييف والتلفزة، وأخيراً أجهزة الهواتف المحمولة. وقد أظهرت التجربة أن جميع هذه الأدوات التي تحمل علامة "صُنع في الصين" قد أثبتت أنها تضاهي نظيراتها المصنوعة في هذا البلد الأجنبي أو ذاك، أضف إلى ذلك امتياز الصناعة المحلية بما تقدمه من خدمات ما بعد البيع، حيث انتبه الصانعون الصينيون إلى أهمية تحسين مثل هذه الخدمات. أما بالنسبة لقطاع السيارات، فإن كبرى شركات صناعتها الصينية تقوم ببيعها تحت ماركات أجنبية مثل فولكسفاجن أو بيجو أو ستروين أو نيسان وبحيث تتم صناعتها بالشراكة مع الشركات الأجنبية المعنية. وفي هذا الميدان أيضاً بدأت بعض الماركات الوطنية بتعزيز مواقعها وتحقيق نجاحات كبيرة مثل سيارة "كوكو" التي تصنِّعها مجموعة "شيري" الصينية وكانت شركة جنرال موتورز الأميركية قد اتهمت الشركة الصينية بأن سيارتها إنما هي "نسخة" أمينة لأحد نماذج سيارات "الشيفروليه" التي تنتجها. من جهة أخرى، دلّ التصنيف الذي قدمته مجلة "فوربس" الشهيرة لعام 2005 على وجود ثلاث شركات صينية بين الـ 50 شركة التي حققت أكبر الأرقام في عملياتها التجارية على الصعيد العالمي. وتحتل مجموعتان بتروليتان هما "صينوبك" و"الشركة الوطنية الصينية للنفط" (شاينا ناشيونال بتروليوم) المرتبتين الـ 31 بالنسبة للأولى والـ 46 بالنسبة للثانية، بينما تحتل شركة توزيع الكهرباء الرئيسية في البلاد ـ ستايت غريد كورب ـ المرتبة 40. وفي المحصلة، وبعد أن كان الدور الرئيسي المناط بالشركات الوطنية الصينية هو تأمين فرص العمل للمواطنين وسد حاجات التنمية الداخلية للبلاد، أصبح مطلوباً من هذه الشركات "غزو العالم" وبحيث تصبح هي نفسها شركات "متعددة الجنسيات". وكان العديد من الشركات الصينية قد أنشأت فروعاً لها منذ مطلع سنوات الثمانينات في هونغ كونغ بقصد الاستفادة من الامتيازات الضرائبية الممنوحة للشركات الأجنبية وحيث يمكن الاستفادة من رؤوس الأموال في أسواق البورصة. بل لجأت شركات صينية أخرى إلى فتح فروع لها في ما يُسمّى بـ "الجنان الضرائبية" مثل جزر فييرج وجزر كايمان. ويشير المؤلف في هذا الإطار إلى أن مجموعة "هاير" الصينية لصناعة الأجهزة الكهربائية المنزلية كانت من بين أوائل الشركات الصينية التي مارست نشاطها الصناعي في الخارج. وكانت هذه الشركة قد أبرمت اتفاقاً مع رجل أعمال أميركي هو مايكل جمال من أجل بيع البرادات الصغيرة للولايات المتحدة الأميركية، وذلك قبل أن تفتتح بعد خمس سنوات وبالتعاون مع رجل الأعمال الأميركي مصنعاً في ساوث كارولينا، ثم بعد ثلاث سنوات قامت المجموعة الصينية ببيع أكثر من 250 نموذجاً ـ موديلاً ـ من الأجهزة الكهربائية المنزلية في الولايات المتحدة الأميركية. إن الصين لا تكتفي بتلقي ما بين 50 و60 مليار دولار سنوياً من الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الأخيرة، لكنها تتحرك أيضاً بالاتجاه المعاكس وإن يكن بخطوات بطيئة، وإنما تزداد تسارعاً شيئاً فشيئاً. وقد بلغت قيمة الاستثمارات الصينية في الخارج لعام 2005 مبلغ 9, 6 مليارات دولار، أي بزيادة 25% خلال سنة واحدة. أما قيمة "مخزون" الاستثمارات الصينية في الخارج فقد تجاوزت الـ 50 مليار دولار في نهاية عام 2005. وتتم الإشارة في هذا الإطار أيضاً إلى تزايد نشاطات الشركات الصينية العاملة في قطاعي البناء والأشغال العامة خلال السنوات الأخيرة وخاصة في البلدان العربية وإفريقيا. لكن من اللافت للانتباه أن المشاريع التي تقوم الشركات المعنية بتنفيذها لا تؤدي إلى فائدة كبيرة بالنسبة لإيجاد فرص العمل في البلدان التي تعمل بها، ذلك أن هذه الشركات قد تعوّدت على أن تستقدم معها القسم الأكبر من العاملين من الصين نفسها، ربما في ذلك البلدان التي تتوفر فيها اليد العاملة مثل حالة الجزائر. العلم في خدمة التقدم حققت الصين خلال السنوات الأخيرة العديد من الأرقام القياسية في ميادين الإنتاج المختلفة، وتضيف لذلك رقماً قياسياً آخر في عدد الطلبة الذين ترسلهم الى الخارج للدراسة. وكان أكثر من 62000 طالب صيني غادروا بلادهم خلال العام الدراسي 2004-2005 لمتابعة علومهم في مختلف الجامعات العالمية. وكانت سنوات 1978 - 3002 قد شهدت توجّه أكثر من سبعمئة ألف شخص للدراسة في البلدان الأخرى من بينهم نسبة كبيرة اتجهت الى الولايات المتحدة الأميركية حيث يوجد حالياً حوالي مئة وخمسين ألف طالب.. كذلك تتواجد أعداد مهمة من الطلبة الصينيين في بريطانيا وايرلندا، وهي أعداد في تزايد مستمر، اذ بلغ عددهم 57000 طالب في بريطانيا عام 2004 وتمثل نفقات الدراسة التي يدفعها الطلبة الصينيون في البلدين، أي بريطانيا وايرلندا احد المصادر المهمة بالنسبة لمداخيل الجامعات.. بل وتتواجد أعداد مهمة من طلبة المرحلة الثانوية الصينيين في المدارس الثانوية البريطانية. واذا كان من المألوف خروج الطلبة للدراسة في الجامعات الغربية ثم عدم عودتهم للبلاد اذ لم يعد مثلاً سوى ربع الطلبة الصينيين الذين خرجوا للدراسة خلال الربع قرن الأخير، أو أكثر من ذلك بقليل، الا ان الميل نحو العودة قد تعزز ومتسارع منذ قرار السلطات الصينية المضي أبعد فأبعد في عملية خصخصة الاقتصاد الصيني مما تزامن وتواكب مع زيادة كبيرة في الاجور خاصة بالنسبة للكوادر القادمين من الخارج، وحتى في المؤسسات التابعة للدولة. وتتم الإشارة في هذا السياق الى ان اغلبية الطلبة الصينيين الذين كانوا يخرجون للدراسة مع انفتاح الصين على العالم الخارجي في بداية سنوات الثمانينات، إنما كانت الحكومة هي التي تختارهم وترسلهم للدراسة. اما اليوم فإن أغلبية الطلبة الصينيين الدارسين في الخارج، وكذلك في داخل البلاد، إنما يقومون بذلك على أساس تمويل أهاليهم وليس تمويل الدولة. ويتم التأكيد على ان الصينيين العائدين من وراء البحار، والذين تطلق عليهم تسمية "سلاحف البحر" التي تعود كي "تضع بيوضها" على الشواطئ التي كانت قد ولدت عليها، يلعبون دوراً أساسيا في القطاع الخاص الصاعد في الصين، لاسيما في ميدان تكنولوجيا الاتصال والصحة وصناعات الأدوية، لكن اذا كانت الشركات الأجنبية تلجأ كثيراً إلى توظيف الصينيين الذين قد عاشوا تجربة الدراسة والتدريب في الغرب وتأثروا ثقافياً به فإن البلدان الغربية، وخاصة الولايات المتحدة تبدي تخاوفاتها من "التجسس الصناعي" الذي قد يقوم به الطلبة الصينيون. هذا وقد توقع تقرير أعدته وزارة التجارة الأميركية في نهاية عام 2005، منع أي شخص مولود في الصين، وحتى لو كان يحمل جنسية أخرى، من العمل في ميادين التكنولوجيات الحساسة، فـ "سلاحف البر" قد تنشط على الأرض أيضا. عرض ومناقشة: محمد مخلوف
|
|
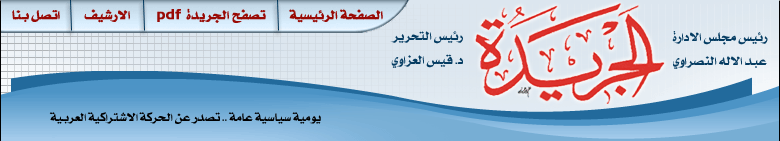
![]()